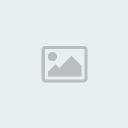الباب الحادى عشر: فى علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه.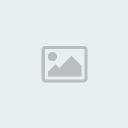
هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب، ثم تنبعث منها إلى الأعضاء.
وأول ما تنال القلب.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبة الحاجة:
"الحمدُ لله نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهدِيهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا".
وفى المسند والترمذى:
من حديث حُصين بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "يَا حُصَيْنُ، كَمْ تَعْبُدُ؟ قال: سَبْعَةٌ، سِتَّةٌ فى الأرْضِ وَوَاحِدٌ فى السَّماءِ، قالَ: فَمنِ الَّذِى تُعِدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قالَ: الَّذِى فى السَّماءِ. قالَ: أَسْلِمْ حَتَّى أُعَلّمَكَ كَلمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بهَا، فأَسْلَمَ.
فَقَالَ: قُلِ: اللهُمَّ أَلْهِمْنى رُشْدِى، وَقِنِى شَرَّ نَفْسِى".
وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من شرها عموماً، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس وسيئات الأعمال.
وفيه وجهان: أحدهما:
أنه من باب إضافة النوع إلى جنسه، أى أعوذ بك من هذا النوع من الأعمال.
والثانى:
أن المراد به عقوبات الأعمال التى تسوء صاحبها.
فعلى الأول:
يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها.
وعلى الثانى:
يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها.
ويدخل العمل السيئ فى شر النفس.
فهل المعنى:
ما يسوءنى من جزاء عملى، أو من عملى السيئ؟ وقد يترجح الأول، فإن الاستعاذة من العمل السيئ بعد وقوعه إنما هى استعاذة من جزائه وموجبه، وإلا فالموجود لا يمكن رفعه بعينه.
وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم، وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها.
فإن الناس على قسمين:
قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها.
وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها، فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم.
قال بعض العارفين:
انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم.
فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك.
قال تعالى:
{فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الحياةَ الُّدنْيَا * فَإنَّ الجحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى وَأمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنّ الجنَّةَ هِىَ المَأْوَى} [النازعات: 37 - 41].
فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرَّب يدعو عبده إلى خوفه ونهى النفس عن الهوى.
والقلب بين الداعيين:
يميل إلى هذا الداعى مرة وإلى هذا مرة وهذا موضع المحنة والابتلاء، وقد وصف سبحانه النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة، والأمارة بالسوء، واللوامة.
فاختلف الناس:
هل النفس واحدة، وهذه أوصاف لها؟ أم للعبد ثلاث أنفس؟: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة.
فالأول قول الفقهاء والمتكلمين وجمهور المفسرين وقول محققى الصوفية.
والثانى قول كثير من أهل التصوف.
والتحقيق:
أنه لا نزاع بين الفريقين، فإنها واحدة باعتبار ذاتها، وثلاث باعتبار صفاتها.
فإذا اعتبرت بنفسها فهى واحدة، وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى فهى متعددة، وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس قائمة بذاتها مساوية للأخرى فى الحد والحقيقة، وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث أنفس، كل واحدة مستقلة بنفسها.
وحيث ذكر سبحانه النفس، وأضافها إلى صاحبها، فإنما ذكرها بلفظ الإفراد، وهكذا فى سائر الأحاديث، ولم يجئ فى موضع واحد "نفوسك" و "نفوسه" ولا "أنفسك" و"أنفسه" وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم، كقوله: {وَإذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ} [التكوير: 7] أو عند إضافتها إلى الجمع، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ".
ولو كانت فى الإنسان ثلاث أنفس لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه ولو فى موضع واحد.
فالنفس إذا سكنت إلى الله، واطمأنت بذكره، وأنابت إليه، واشتاقت إلى لقائه، وأنست بقربه، فهى مطمئنة، وهى التى يقال لها عند الوفاة.
{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمِئنَّةُ ارْجِعِى إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةَ} [الفجر: 27-28].
قال ابن عباس:
"يا أيتها النفس المطمئنة"، ارجعى إلى ربك راضية مرضية يقول: المصدقة.
وقال قتادة:
"هو المؤمن، اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله".
وقال الحسن:
"المطمئنة بما قال الله، والمصدقة بما قال".
وقال مجاهد:
"هى المنيبة المخبتة التى أيقنت أن الله ربها، وضربت جأشا لأمره وطاعته، وأيقنت بلقائه".
وحقيقة الطمأنينة:
السكون والاستقرار، فهى التى قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضى به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسْبِه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين.
وإذا كانت بضد ذلك فهى أمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه: من شهوات الغى، واتباع الباطل، فهى مأوى كل سوء، وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه.
وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء، ولم يقل "آمرة" لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله، لا منها.
فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت فى الأصل جاهلة ظالمة، إلا من رحمه الله، والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها.
فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم، فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة.
فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح: من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التى خلقت عليها من الجهل والظلم.
وسبب الظلم:
إما جهل، وإما حاجة. وهى فى الأصل جاهلة.
والحاجة لازمة لها، فلذلك كان أمرها بالسوء لازما لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله.
وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك.
فصل
وأما اللوامة فاختلف فى اشتقاق هذه اللفظة، هل هى من التلوم، وهو التلون والتردد، أو هى من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين.
قال سعيد بن جبير:
"قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هى النفس اللئوم".
وقال مجاهد:
"هى التى تُنَدِّم على ما فات وتلوم عليه".
وقال قتادة: "
هى الفاجرة" وقال عكرمة: "تلوم على الخير والشر".
وقال عطاء عن ابن عباس:
"كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسىء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته".
وقال الحسن:
"إن المؤمن، والله، ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته؛ يستقصرها فى كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضى قدما لا يعاتب نفسه".
فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم.
وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها، وأنها لا تستقر على حال واحدة.
والأول أظهر، فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلومة. كما يقال: المتلونة والمترددة.
ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشىء ثم تلوم عليه. فالتلوم من لوازم اللوم.
والنفس قد تكون تارة أمارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، بل فى اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا.
والحكم للغالب عليها من أحوالها، فكونها مطمئنة وصف مدح لها.
وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها.
وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم، بحسب ما تلوم عليه.
والمقصود:
ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله علاجان: محاسبتها، ومخالفتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها، ومن موافقتها واتباع هواها، وفى الحديث الذى رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكَيسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله" دان نفسه: أى حاسبها.
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال:
"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وَتَزَيَّنوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية".
وذكر أيضا عن الحسن قال:
"لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: وماذا أردت تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين؟ والفاجر يمضى قدما قدما لا يحاسب نفسه".
وقال قتادة فى قوله تعالى:
{وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} [الكهف: 28]، أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه.
وقال الحسن:
"إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته".
وقال ميمون بن مهران:
"لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوَّان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك".
وقال ميمون بن مهران أيضاً:
"إن التقى أشد محاسبة لنفسه من سلطان عَاصٍ، ومن شريك شحيح".
وذكر الإمام أحمد عن وهب قال:
"مكتوب فى حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وإجماماً للقلوب" وقد روى هذا مرفوعًا من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره.
وكان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح، فيضع أصبعه فيه، ثم يقول:
حس يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ويبكى.
وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله:
"حاسب نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدة فإن من حاسب نفسه فى الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة".
وقال الحسن:
"المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشىء ويعجبه، فيقول: والله إنى لأشتهيك. وإنك لمن حاجتى، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حيل بينى وبينك، ويفرط منه الشىء فيرجع إلى نفسه، فيقول: ما أردت إلى هذا؟ مالى ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا، إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم، إن المؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه فى سمعه وفى بصره، وفى لسانه، وفى جوارحه، مأخوذ عليه فى ذلك كله".
يتبع إن شاء الله...